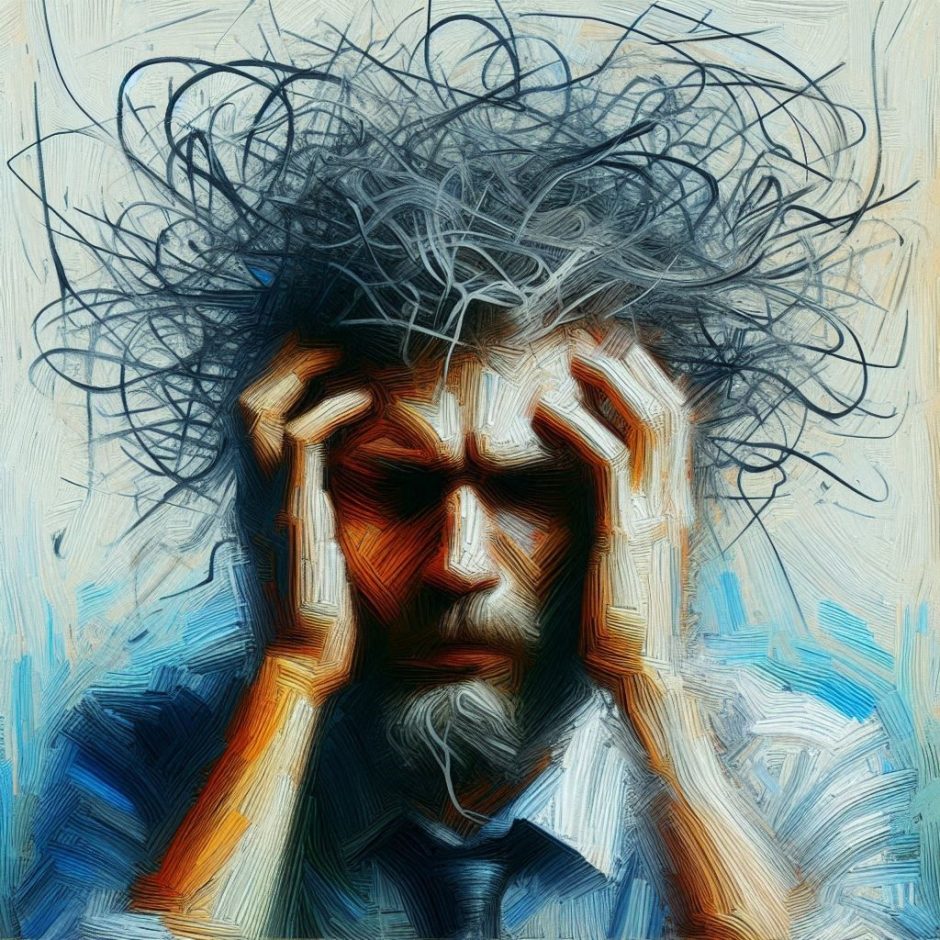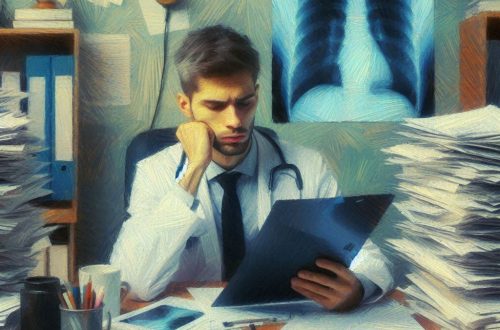الاعتقاد بأن المرض العضوي قد يكون نابعًا من المرض النفسي، أو سببه العقل، ظل ولمدة طويلة جاذبًا وآسرًا لمخيلة الأطباء والكتاب على حد سواء.
مثل هذه التشخيصات انبنت عليها الكتب الطبية التي تركها الأطباء الملكيون بإنجلترا في القرن السادس عشر، بالإضافة إلى أعمال موليير كمسرحيته «مريض الوهم» Le Malade imaginaire عام 1673، وكذلك أوصاف مرض «الهيستيريا»، التي عادة ما تكون محيرة، والتي وضعها طبيب الأعصاب الفرنسي جان مارتن شاركو وزملاؤه ممن عملوا في مستشفى سلبتريير في القرن التاسع عشر بباريس، فضلًا عن كتابات سيجموند فرويد في القرن العشرين، والذي كان تلميذاً لشاركو في يوم من الأيام. بالإضافة أيضًا إلى الأنواع الأدبية الجمالية التي كتب فيها مؤلفون مثل هنري جيمس، والذي اعتُبرت أخته أليس مصابة بالهيستيريا، وقد امتلأت تلك الأنواع الأدبية التي ركزت على الفترة القوطية بشخصيات أمرضتها عقولها. وحديثًا أُعِيدَ إحياء تشخيص الهيستيريا، الذي صار يطلق عليه مسمى اضطراب التحول، وأصبح شائعا بين الأطباء، ومقبولًا لدى المرضى. على سبيل المثال وصفت الروائية سيري هوستفيدت كيف تجلَّى ضغطها النفسي في شكل إعاقة جسدية بالغة، وذلك في سيرتها الذاتية التي نشرت عام 2010 بعنوان «المرأة المضطربة» The Shaking Woman.
قد يبدو منافيًا للعقل أن يتبنى المرء موقفًا متشككًا في هذه الأفكار المتأصلة ثقافيًا وطبيًا، لكن يقترح بحثي أن التفسيرات النفسية للحالات العضوية قد تكون خطيرة؛ وذلك لاحتوائها على الكثير من الأفكار المشوشة والأخطاء في براهينها، ومشاكل أساسية في منهجيتها، وتدعي على نحو مثير للسخرية أن لها أساسًا علميًا. تشبه مثل هذه التفسيرات نظرية إله الفجوات (god of gaps)؛ والتي فيها يتسرب الخيال -وفي بعض الأحيان القصص الوهمية- إلى الحجج الطبية كلما كانت هناك فجوة معرفية. وتستند هذه التفسيرات إلى افتراضات مسبقة عن الأشخاص وكيفية اعتلال صحتهم.
ومع ذلك، فهناك إصرار غريب على أن المرض العضوي هو نتيجة الضغوط النفسية الاجتماعية، ويشيع هذا الإصرار في كل من الإعلام الشعبي والمؤلفات الطبية. وها هي بعض الأمراض التي توصف بذلك: ارتفاع ضغط الدم، والشكاوى الجلدية، والصداع النصفي، واضطرابات الدورة الشهرية، والسرطانات، وداء التصلب المتعدد، والجذام، ومرض لايم، والتهاب الدماغ والنخاع الشوكي المؤلم للعضلات، وداء الشلل الرعاش، والسكري، والصداع، وأوجاع البطن، والمشاكل التناسلية ومشاكل النمو، واختلال وظائف المعدة والأمعاء، والمشاكل المناعية، والإرهاق، ونقص إفراز الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والإنفلونزا والبرد. كثرة هذه الحالات التي يُعْتَقَد أن مسببها الضغط العصبي كافية لإثارة الريبة والشك بالنسبة للباحث والناقد العلمي.
من الأخطاء المنطقية في مثل هذه الحجة أن أحداث وظروف الحياة الضاغطة نفسها توجد في كل وقت، وقد استوعب ذلك طبيب الأعصاب البريطاني إليوت سلايتر في دراسته المنشورة عام 1965 حينما قال: «لسوء الحظ علينا أن نعترف أن مشاعر الانزعاج والتوتر والإحباط وعدم الانسجام منتشرة للغاية في جميع مراحل الحياة، وأن مجرد الشعور بها بالقرب من وقت ظهور أعراض المرض لا يعني الكثير». وحتى أحداث وظروف الحياة الإيجابية من الممكن أن تكون ضاغطة.
وما هو أكثر من ذلك أنه من الصعب التعويل على ذكريات الأحداث الضاغطة، خصوصًا إذا كان استرجاع هذه الأحداث التي يحكي عنها أصحابها يتأثر بتوقعات الباحثين. فالأشخاص أو العائلات الذين يعانون من مرض ما أسبابه مجهولة، أو لا يمكن الجزم بها، تزيد احتمالية أن يتخيلوا علاقة سببية بين المرض والأحداث الحياتية العسرة. على سبيل المثال، وجدت دراسة عام 1960 أن أهالي المصابين بمتلازمة داون قد أفادوا بتعرضهم لصدمات أكثر أثناء فترة الحمل مما أفادت به مجموعة المقارنة. بَيْدَ أن متلازمة داون مرض جيني يحدث في بداية الحمل «لم تكن هذه المعلومة مكتشفة بعد أثناء القيام بهذه الدراسة»، ومن المفارقة أن أعضاء مجموعة المقارنة الذين يتمتعون بصحة جيدة ربما يميلون إلى التقليل من التجارب الحياتية العَسِرَة التي يمرون بها، وإلى المبالغة في قدرتهم على التحكم في ظروفهم. أما المرضى فتزيد احتمالية أن يبلغوا عن تعرضهم للأحداث العسرة، والتي يفترض الباحثون خطأً وجود علاقة مباشرة بينها وبين المرض نفسه.
الخلط بين المرض النفسي والعضوي أصبح الآن موضوعًا للعديد من الكتب، ومن ضمنها كتاب للمؤلفة دونا جاكسون ناكازاوا بعنوان «طفولة مضطربة» Childhood Disrupted الصادر عام 2015. بالأخص تسجِّل ناكازاوا شهادات ناجين من تجارب الطفولة العسرة، وهي مجموعة تتابعها مراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وشركائها في دراستهم الطويلة والضخمة على مثل هذه التجارب. يمكن أن تكون لهذه الدراسة نوايا حسنة، ولكنها عرضة لنفس المشكلات في الخلط، ومن المحتمل أن تُستخدم في لوم الضحية.
هذا الميل للتسليم بالآليات الغامضة التي يُزعم أن العقل من خلالها يصنع المرض تتجلى في اللغة التي نستخدمها لوصف هذه العملية، بمصطلحات مثل مفاتيح التشغيل، والصناديق السوداء، والمحور الوطائي النخامي الكظري، وما هي إلا أمثلة قليلة. لا تعني هذه المصطلحات الكثير، والآليات الفسيولوجية المؤكدة والمفسرة للضغط النفسي المجتمعي، وبالأخص تلك التي تسبب الأمراض، من السرطان إلى نزلات البرد، ما زالت غائبة حتى المرحلة الحالية من البحث العلمي.
وفي واحدة من النسخ الضارة لهذه الحجج، يُزعم أن أنواعًا معينة من الشخصيات قد تكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة ببعض الأمراض، على سبيل المثال، تُعتبر الشخصية من النوع «أ» أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن لا توجد سوى صلة ضعيفة بين نوع الشخصية المبني على المشاعر والأفكار وبين أمراض القلب والأوعية الدموية. كما زُعم مؤخرًا أن هناك أنواعًا أخرى من الشخصيات قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من ضمنها الشخصية من النوع «د» أو الشخصية المكروبة. يعني ذلك أن أي فعل من شخص مريض يعتبره الناس سلبيًا قد يروه مسببًا للمرض.
وهناك نوع شخصية آخر يُقترح أنه ذو تأثير على سرطان الثدي، وهو الشخصية الاجتنابية. تشمل هذه الفئة السيدات هادئات الطباع الغير تنافسيات، اللاتي يَكُنَّ في علاقات شخصية تتسم بالانسجام. هذه الفكرة تزعم أن السيدات المصابات بسرطان الثدي غير المتعاونات واللاتي يملن إلى النزاع سيعشن أكثر من نظيراتهن المهذبات اللاتي لا يملن إلى الانفعال. وعند تتبع تلك الافتراضات وصولا إلى نتائجها النهائية، سنجد أنفسنا نؤمن بأن الشخصية من النوع «أ» آمنة من سرطان الثدي، لكنها ستموت على الأرجح بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبالإضافة إلى ما تسببه تلك الافتراضات النفسية من إهمال للمرض العضوي، بمعنى تركه بلا تحرٍّ أو علاج، فهذه التفسيرات النفسية في الواقع تعتبر شخصية المريض هي منشأ المرض، وتدفع المرضى إلى لوم أنفسهم.
يثير ذلك مشاكل أخلاقية خطيرة. فهل من الصواب مثلا أن نقول للنساء إن نجاتهن من مرض سرطان الثدي تعتمد على تقليل المجادلة أو كثرة الثرثرة، أو على تغيير شخصياتهن، بينما تلك الأفكار غير مُثبَتة؟ وعلى المنوال نفسه، هل يجب على الرجال والنساء المعتلين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ممن يُعْتَبَرون من نوع الشخصية «أ» أو حتى «د» التي تصنف كشخصيات قلقة، أن يعانوا من ضغوط أكبر من خلال حملهم على الاعتقاد بأن أنواع شخصياتهم قد دمرت صحتهم؟
على الرغم من أن التفسيرات النفسية للأمراض العضوية جذابة، فإن الفكرة الشائعة التي تقول بأن «أفكارنا هي ما يُمْرِضُنا» لا تدعمها الأدلة المتاحة. وهي مليئة بالمغالطات في حججها، وتسبب الضرر لمن تنطبق عليهم.
هذا المقال مُترجم عن مجلة «إيون» Aeon، كتبته أنجيلا كينيدي، وهي محاضرة جامعية وباحثة مستقلة في علم الاجتماع. وقد حرَّر المقال الأصلي بام وينتروب، وساعد في تحرير الترجمة العربية د. محمد الوكيل.
طبيبة بيطرية، شغوفة بالترجمة.