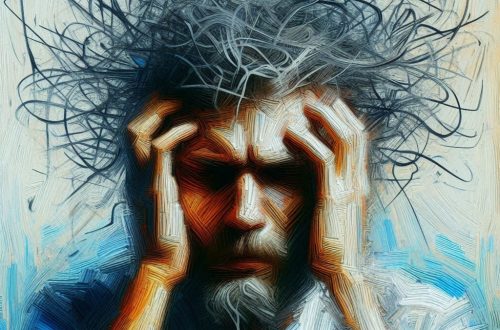«لا أحب تناول الأدوية». هذا ما أخبرني به هرناندو عندما أوصيتُه بتناول جرعة قوية من الإيبوبروفين من أجل الألم في إبهامه، في يومٍ كان مزدحمًا أكثر من المعتاد في عيادة الرعاية الأولية حيث أعمل. لستُ طبيبه الذي اعتاد زيارته، لذا حاول أن يشرح أنَّه يفضل العلاجات الطبيعية على المستحضرات الصيدلانيَّة المصنوعة. قلتُ لنفسي إنَّه يمكننا الاستعانة بها، لكنَّه استدرك قائلًا: «أفضِّل ألَّا أرتدي دعامةً للمعصم»، وهذه الدعامة هي عنصر مفتاحي لعلاج التهاب الأوتار لديه.
لا تسير هذه الزيارة كما تمنيت. كنتُ متعجلًا ومتأخرًا لأربعين دقيقة عن جدولي بالفعل، وأتمنى أن أتدارك الوقت، إلا أنَّ موعدي مع هرناندو تطلب الكثير من الوقت للتعامل مع تفضيلاته، وللتصارُع مع النظام الإلكتروني العتيق للسجلات حين طلب خطابًا يجيز له أن يتغيب عن العمل. عند هذه اللحظة كنتُ أكثر إجهادًا مما كنتُ عليه قبل هذه الزيارة، وبدا عليَّ الضيق، ولم يكن هو الآخر سعيدًا.
شاعرًا بالخجل، أسرعتُ إلى المريض التالي وأنا أفكر: «لم يسِر الأمر على ما يرام».
مثل هرناندو، يريد الجميع طبيبًا يتفهم حالتهم الشعورية، يصف الأدوية لكنَّه أيضًا يستمع ويتفهم. لكنَّ المرضى يتذمرون بحق من كون الأطباء في العيادات والمشافي قد أصبحوا أقل تفهمًا لهم. وقد وجد الباحثون أنَّ مستويات تفهُّم طلاب الطب لمشاعر المرضى تنخفض على مدار مسارهم التعليمي، وتُعبِّر الدوريات الطبية عن حسرتها على تراجعها لدى الأطباء. وبينما تركز غالبية الأبحاث المعنية بفهم وسد هذه الفجوة على تدريب الأطباء فردًا فردًا، إلَّا أنَّ هذه الفكرة ستفشل حتمًا لو ظلت بيئة العمل بلا تغيير.
يكمُن المفتاح في طبيعة التفهم الإكلينيكي للمرضى، والتي تتطلب تركيزًا تامًا من الطبيب الممارس؛ أن يتملكه الفضول بما يكفي ليُعنِي ذهنيًا وعاطفيًا بوضع المريض ومنظوره ومشاعره، ثم يعبر له عن تفهمه لها.
في بعض الأوقات، يبدو أنَّ هذا التفهم تأثيره ليس بيولوجيًا بقدر ما هو سحري. فعندما ترتفع مستوياته يتعافى المرضى من نزلات البرد بشكلٍ أسرع، ويتمكن مرضى السكري من التحكم على نحوٍ أفضل في سكر الدم، ويلتزم الناس بأنظمة العلاج التزامًا أكبر، ويشعر المرضى بأنَّهم أقدر على التعامل مع أمراضهم. كما يُفيد الأطباء الذين يتفهمون المرضى بأنَّهم يعيشون حياةً أفضل، ويُقاضَوْن بمعدلٍ أقل.
لكن حتى إذا كانت أهمية تفهُّم المرضى واضحة، فإنَّ الطريق إلى تعزيز تلك الممارسات ما تزال ضبابية. فالأبحاث الجديدة تبين أنَّ التأمُّل والتواصل الواعي مع المرضى يمكن أن يزيدا من تفهم الأطباء لهم، وهو ما أدى إلى مجالٍ متخصص لإعداد الدورات التدريبية. لكنَّ هذا الانشغال الشديد بالأطباء أغفل العيوب الصارخة في بيئة العمل، والتي تسحق قدرة الأطباء على تفهُّم المرضى.
هذي هي القصص التي تسمعها عند تحدثك مع أطباء الخطوط الأمامية، أو عندما تقرأ العدد الهائل من النصوص التي يكتبها الأطباء وطلاب الطب حين يغادرون المجال أخيرًا.
يتحسر الكثيرون منهم كيف أنَّ بيئة الممارسة تمنعهم من الاعتناء بمرضاهم بالطريقة التي كانوا يرجونها ويستحقها مرضاهم. فيقول مثلًا أحد المعلِِّقين: «أصبح من المستحيل أن تتمكن من تفهُّم حالة المريض بينما تُقاطَع باستمرار بواسطة الممرضات، ومكالمات المرضى، وطلبات كتابة التعليمات باستخدام أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية العتيقة غير المصممة للأطباء». وهم يلومون الضغط الزمني الواقع عليهم بسبب أنظمة المُطالبة بقيمة الخدمات الطبية التي يوفرونها، فهذه الأنظمة تُقدِّم عدد المرضى على جودة الخدمة. كما يُعزون تلك المشكلة إلى عدم تحكمهم في بيئة العمل الفوضوية، والوقت اللانهائي المُستغرَق في المهام الإدارية. وربما من غير المُستغرَب أنَّ كثيرًا من هذه العوامل هي نفسها التي تساهم في معاناة الأطباء من الاحتراق الوظيفي.
وهذه هي القصة نفسها لما مررت به مع هيرناندو. التقينا في أصعب يومٍ من أسبوعي في العيادة، وكنتُ متأخرًا، إلى جانب شعوري بالإرهاق المعتاد. لم أكن أعرفه على الإطلاق، ما استدعى من كلينا التعامل فورًا مع تفضيلاتنا للطب البديل أو الطب التقليدي.
وكان للاحتراق الوظيفي دورٌ أيضًا. فقد قابلتُ هرناندو خلال أصعب فترات تدريبي، فترة لم أحصل فيها على إجازة سوى لتسعة أيام على مدار اثني عشر أسبوعًا؛ وكنتُ أعمل ما يقرُب من ثمانين ساعة عمل في الأسبوع، ولا أملك أي طاقة لأعتني بنفسي، ناهيك عن مرضاي. ومع معاناتي من الحرمان المزمن من النوم، تعطلت دوائر التعاطف لدي، وهي معضلة معروفة في التعليم الطبي الحالي. ليس هذا بعذر بالتأكيد، فأنا أضع معيارًا لنفسي أعلى مما كان عليه ذلك الموعد مع هرناندو، لكنَّني كنتُ احتاج الراحة أكثر من حاجتي إلى دورة تدريبية على حضور الذهن.
لكن بخلاف القصص التي يرويها الأطباء، فلن تجد دراسات في الدوريات الطبية تختبر تأثير قلة الفوضى في المستشفيات، أو زيادة مدة مواعيد زيارات الرعاية الأولية، على قدرة الأطباء على تفهم المرضى. ليس الأمر أنَّ الباحثين في هذا الشأن يتجاهلون هذه العوامل البيئية؛ ففي الحقيقة، تذكُرها كثير من الأوراق البحثية بشكل عابر، لكنَّ الأمثلة على الدراسات التجريبية التي تتناولها في المجال الطبي قليلة.
بعيدًا عن الطب، فالعلاقة بين البيئة المحيطة وقدرة الأطباء على تفهُّم المرضى معروفة منذ أربعة عقود. ففي دراسة جامعة برنستون الشهيرة عام 1973، اُختبر طلاب معهد ديني في السلوك الإيثاري في موقف مُوتِّر مفتعل.كُلِّف الرجال بإلقاء كلمة إمَّا عن شخصية السامري الصالح، أو عن الحصول على وظيفة جيدة، وبعضُهم أُخبروا بأنَّهم متأخرون بالفعل عن موعدهم، والآخرون قيل لهم أنَّ لديهم متسعٌ من الوقت. خلال الطريق كان عليهم المرور بزقاقٍ توجد فيه ضحية مزيفة مُمدَّدة تمر بأزمة، تسعل وتبدو فاقدةً للوعي. والسؤال كان: هل سيتوقفون لمد يد العون؟
هؤلاء الطلاب، الذين اختاروا أن يعيشوا حياةً دينية لمساعدة الناس، والذين كانوا يعرفون بوضوح قصة السامريَّ الصالح، بل وبعضهم أُوعِزَ إليه بأن يفكر فيها، كان من المفترض بهم التوقف للمساعدة، لكنَّهم لم يفعلوا! ففي واقع الأمر، لم يكن العامل الرئيسي المرتبط بتقديمهم المساعدة هو شخصياتهم، ولا حتى ما إذا كانوا من المُكلَّفين بالحديث عن السامري الصالح، وإنَّما كان مقدار الوقت المتوفر لهم للوصول.
فبفعل ضغط الوقت، بعض الطلاب لم يعتبروا المشهد في الزقاق مناسبةً لاتخاذ قرارٍ أخلاقي. بعضهم اعتبرها كذلك، ولُوحظ كم كانوا متوترين وقلقين بعد أن التقوا بالضحية. لقد طُلِب منهم المساعدة، فأصبحوا أسرى صراعٍ بين التزامهم بإلقاء الكلمة في موعدها، وبين مساعدة الضحية في الزقاق. وكما قال الباحثون، فإنَّ «الصراع، وليس القسوة واللامبالاة، هو ما يمكن أن يفسر فشلهم في التوقف للمساعدة».
الآثار المترتبة على ذلك عميقة. فقد يتسبب ضغط الوقت في تعطيل القدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية، أو في المعاناة من صراعٍ داخلي يطغى على الميل الفطري لتقديم المساعدة لمُحتاجيها. يحدث هذا يوميًا في المستشفيات والعيادات، حيث يعمل مقدمو الرعاية الطبية، الذين اتجه كثيرٌ منهم لممارسة الطب بدافعٍ من رغبتهم في مساعدة الناس، ليجدوا نفسهم مُكلفين بخدمة سيدين: المريض الذي يعاني في عيادتهم، والنظام الذي يتطلب منهم مقابلة مرضى أكثر وبمعدلٍ أسرع. يخلق هذا صراعًا داخليًا يمكنه تفسير ما يظهر كأنَّه «سلوكٌ قاسٍ»، يبدو فيه الأطباء وكأنَّهم يغفلون كثيرًا من تلميحات المرضى، الذين يحتاجون من يتفهم مشاعرهم واحتياجاتهم. ينتج هذا الوضع بيئةً، بحسب ما خلصت إليه دراسة برينستون، يصبح فيها «قرار المساعدة قرارًا فوريًا، مُحكومًا بالظروف والموقف».
ولم يعد هذا مفاجئًا بعد اكتشاف «الخلايا العصبية المرآتية»، التي يُعتقد أنَّها المراكز العصبية البيولوجية للقدرة على تفهُّم مشاعر الآخرين. فالخلايا المرآتية تُثار عندما نلاحظ الناس، ويمكنها بشكلٍ لا واعٍ أن تعكس المشاعر التي نتلمسها في الآخرين. لكنَّها خلايا هشَّة، والتعرُّض لللامبالاة أو العنف في الصغر يُثبِّط من نموها. وحتى الكبار الذين لديهم مساراتٌ عصبية تؤدي وظائفها كاملةً يمكن أن تتعطل خلاياهم المرآتية في المواقف عالية المخاطر، المحكومة بالخوف والضغوط.
وقد بدأت دراسات علم النفس والأنثروبولوجيا مؤخرًا تلقي الضوء على كيفية تأثير الظروف الاجتماعية على قدرتنا على تفهُّم مشاعر الآخرين. فهذه القدرة ليست سمة ثابتة ومتأصلة، إنَّما قد تختلف على مدار اليوم الواحد أو الشهر، وتتقلب مع وضعنا الاجتماعي ومزاجنا وتقديرنا لذواتنا.
لكنَّ هذه التطورات في العلوم الاجتماعية لم تشق طريقها بعد إلى الطب. ونحن بحاجة إلى فهم الظروف التي تزدهر فيها تلك القدرة ازدهارًا طبيعيًا. علينا أن ندرس تأثير إطالة مواعيد الزيارات أو زيادة المقابل المادي للاستشارات التي تستغرق وقتًا طويلًا. لكنَّنا بدلًا من هذا نطالب الأطباء ذوي الجداول المزدحمة بالتدرب على تفهُّم المرضى، دون تغيير ضغوط عملهم، ونلومهم وحدهم على تلك الفجوة.
وحتى تأخذ المستشفيات والعيادات وشركات التأمين العوامل المحيطة على محمل الجد، سيستمر المرضى في المعاناة، وقدرة الأطباء على تفهم مشاعرهم واحتياجاتهم في التراجع.
هذا المقال مُترجم عن مجلة «إيون» Aeon، كتبه ديفيد سكيلز، وهو طبيب متدرب كان يعمل في الماضي باحثًا زميلًا ومتخصصًا في سوسيولوجيا الطب بكلية طب هارفارد، ومارس بعض العمل في مجال الطب مع اللاجئين الفلسطينيين في بيروت ولبنان وعمَّان والأردن. وقد حرَّر المقال الأصلي المحررة بام وينتروب.