«تُنتج النظرية الكثير من التفسيرات، لكنها بالكاد تُقربنا من معرفة سر الإله. في كل الأحوال أنا مقتنع بأنه لا يلعب بالنرد». هذا ما كتبه ألبرت أينشتاين في ديسمبر من عام 1926 ردًا على خطاب الفيزيائي الألماني ماكس بورن. وصف بورن نظرية ميكانيكا الكم الجديدة بأن قلبها ينبض بعشوائية وبتردد، كأنه يعاني من اضطراب في النبض. فبينما كانت الفيزياء الكلاسيكية، قبل ظهور ميكانيكا الكم، ترى أن هناك نتائج محددة لكل حدث، بدا أن ميكانيكا الكم الجديدة تقول إنه عندما يقع حدث ما، فإننا نحصل على نتيجته المتوقعة فقط باحتمال معين، وفي بعض الأحيان قد نحصل على نتيجة مختلفة تمامًا.
لم يقتنع أينشتاين بما قاله بورن. وكان لإصراره على أن الإله لا يلعب بالنرد مع الكون صدى على مر العقود، إذ راجت مقولته هذه رواجا كبيرا مثل معادلة الطاقة E = mc2، لكنها بدت مبهمة مثلها. فما معنى مقولته؟ وكيف كان يتصور أينشتاين الإله؟
هيرمان أينشتاين وبولين أينشتاين، والدا ألبرت أينشتاين، كانا من يهود الأشكناز غير المتدينين. وبالرغم من توجههما العلماني، تعرف ألبرت ذو التسعة أعوام على الديانة اليهودية واعتنقها. شغفه بالديانة اليهودية بدا ملحوظًا وصار متدينًا وملتزمًا لفترة من الزمن. كان الوالدان يدعوان طالب علم فقير ليشاركهم الطعام كل أسبوع اتباعًا للعادات اليهودية. وأحد هؤلاء كان طالب الطب المعدم ماكس تلمود (تالمي كما سيُعرف لاحقًا)، وهو من عرَّف أينشتاين اليافع وسريع التأثر بالرياضيات والعلوم. قرأ أينشتاين بنهم الواحد والعشرين مجلدًا من السلسلة الممتعة «كتب مشهورة عن العلم الطبيعي» لأرون برنشتاين1. عقب ذلك، وجه تلمود أينشتاين إلى قراءة كتاب الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط «نقد العقل الخالص»2. وانتقل بعد ذلك إلى القراءة عن فلسفة الاسكتلندي ديفيد هيوم، ومن ثم القراءة عن فلسفة الفيزيائي النمساوي إرنست ماخ، وكان هذا الانتقال سهلًا نسبيًا3. كانت لدى ماخ فلسفة تجريبية شديدة الصرامة، تقتضي إدراك الأشياء حسيًا لإثبات وجودها، فرفضت هذه الفلسفة رفضًا قاطعًا وجود علم الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) وأفكاره التي تتضمن فكرة الزمان والمكان المطلقين وفكرة وجود الذرات.
كشفت هذه الرحلة الفكرية التناقض بين العلم والنصوص الدينية بلا هوادة، فأدى ذلك لتمرد أينشتاين الذي كان في عمر الثانية عشر. تولَّد لديه شعور بالنفور الشديد تجاه العقائد الجامدة للأديان المنظمة. وهذا النفور استمر طيلة حياته، وشمل كل أشكال الاستبداد الفكري، بما فيها جميع أنواع الإلحاد العقائدي.
هذا الغذاء الدسم من الفلسفة التجريبية الذي تلقاه أينشتاين في صغره ساعده كثيرا في الأعوام الأربعة عشر التالية؛ فمثلًا، ساهم رفض ماخ لفكرة المكان والزمان المطلقين في تشكيل نظرية النسبية الخاصة (شاملة المعادلة الأيقونية E = mc2) التي صاغها أينشتاين في عام 1905 حين كان يعمل خبيرًا فنيًا من الدرجة الثالثة في مكتب براءات الاختراع السويسري في مدينة برن. بعد عشرة أعوام، تغير مفهوم المكان والزمان حين أصدر أينشتاين النظرية النسبية العامة، وفيها استُبدلت قوة الجاذبية وحل محلها الزمكان المنحني. مع تقدمه في العمر، صار أكثر حكمة، وأصبح يرفض ميول ماخ المتشددة في الفلسفة التجريبية، حتى أنه قال ذات مرة «كان ماخ جيدًا في الميكانيكا بنفس قدر بؤسه في الفلسفة».
بمرور الزمن، تطور فكر أينشتاين ليصبح أكثر واقعية. كان يفضل تناول محتوى النظريات العلمية بواقعية، فيراها تمثيلًا صحته محتملة لواقع فيزيائي مجرد. ورغم رفضه لاعتناق أي دين، فإن مبدأ الإيمان بالإله، الذي احتفظ به أينشتاين خلال الفترة الوجيزة التي داعبت فيها فكرة اعتناق اليهودية عقله، أصبح حجر الأساس الذي يبني عليه فلسفته. وحين سُئل عن توجهه الفكري الواقعي، شرح قائلًا: «لا يوجد أفضل من مصطلح «اعتقاد ديني» لوصف ثقتي بأن الواقع منطقي، وبأنه يمكن للعقل البشري فهمه إلى حدٍ ما». لكن الإله الذي آمن به أينشتاين كان إلهًا فلسفيًا وليس إلهًا دينيًا. فحين سُئل بعد عدة أعوام عن إيمانه بالإله، رد قائلًا: «أنا أؤمن بإله سبينوزا الذي يتجلى في التناغم المقنن بين كل ما هو موجود، وليس بإله يعني نفسه بمصير البشر وأفعالهم». باروخ سبينوزا هو فيلسوف يهودي عاصر إسحاق نيوتن وجوتفريد لايبنتز، وكان يتصور أن الإله هو الطبيعة، لهذا السبب اعتُبِرَ مهرطقًا خطيرًا على المجتمع اليهودي في أمستردام وطُرِدَ منه.
الإله الذي يؤمن به أينشتاين متسام إلى أبعد حد، لكنه غير متحيز ولا ملموس، غامض لكنه ليس خبيثًا. كان الإله في نظر أينشتاين إلهًا جبريا، حيث أنه رأى أن التناغم المقنن الذي رسخه الإله في الكون متقيد بالمبادئ الفيزيائية لعلاقة السبب والمسبب، ومن ثم، لم يكن هناك مكان لفكرة الإرادة الحرة في فلسفة أينشتاين، واتضح هذا في قوله «كل شيء محدد، البداية والنهاية، من قِبَل قوى لا نتحكم فيها… جميعنا يرقص على نغمة يعزفها عازف خفي من مكانٍ بعيدٍ».
قدمت نظريتا النسبية الخاصة والعامة طريقة جديدة كليًا لفهم الزمان والمكان وتفاعلهما مع المادة والطاقة. هاتان النظريتان متوافقتان بالكامل مع التناغم المقنن الذي رسخه إله أينشتاين. أما نظرية ميكانيكا الكم الجديدة، التي ساهم أينشتاين نفسه في وضعها عام 1905، كان لها رأي آخر. فتدور ميكانيكا الكم حول تفاعلات المادة والإشعاع على مستوى الذرات والجزيئات، والتي تحدث في المكان والزمان دون أن تتأثر بهما.
في عام 1926، تغيرت نظرية ميكانيكا الكم الجديدة جذريًا على يد الفيزيائي النمساوي إرفين شرودنغر، حين صاغها في صورة الدالات الموجية، التي تتسم بالغموض إلى حد ما4. لكن شرودنجر فضل تفسير هذه الدالات واقعيًا عن طريق اعتبارها وصفًا لموجات المادة. في هذا الحين، كان هناك إجماع ينتشر بين العلماء، بدعم من الفيزيائي الدنماركي نيلز بور والفيزيائي الألماني فيرنر هايزنبرج، بأنه لا يجب التعامل مع التمثيلات الكمية على ما تبدو عليه.
رأى بور وهايزنبرج أن العلم، جوهريًا، قد أصبح قادرًا على التعامل مع المشاكل المفاهيمية في وصف الواقع التي قد حذر منها الفلاسفة لقرون. إذ ذُكر أن بور قال: «ليس هناك عالَم يسمى العالَم الكمي، بل هناك فقط وصف كمي فيزيائي مجرد. من الخطأ الاعتقاد أن مهمة علم الفيزياء تحديد ماهية الطبيعة، بل مهمته تقديم تصور عن ماهية الطبيعة». هذا التصريح، الذي يبدو أنه ينتمي إلى الفلسفة الوضعية، كُرِرَ في قول هايزنبرج: «يجب أن نتذكر أن ملاحظاتنا ليست للطبيعة نفسها، بل لما يظهر من الطبيعة من خلال نهجنا الاستقصائي». وسرعان ما أصبح تفسيرهما اللاواقعي لميكانيكا الكم، والملقب بتفسير كوبنهاجن، هو التفسير السائد. جديرٌ بالذكر أن هذا التفسير أنكر أن الدالة الموجية تعبر عن الحالة الفيزيائية الواقعية لنظام كمي. الصور الأحدث من هذا التفسير اللاواقعي ترى أن الدالة الموجية طريقة لترميز تجربتنا مع الفيزياء، أو قناعاتنا الشخصية المستنبطة من هذه التجربة، لتتيح لنا استخدام ما تعلمناه عن الفيزياء في الماضي للتنبؤ بالمستقبل.
كانت هذه التفسيرات غير متسقة مع فلسفة أينشتاين على الإطلاق. فأينشتاين لم يقبل أي تفسير لميكانيكا الكم يكون أساس تمثيله، أي الدالة الموجية، ليس له وجود في الواقع، ولم يقبل أيضًا الاعتقاد بأن إلهه سيسمح بتفكك التناغم المقنن على مستوى الذرات، لتنشأ حالة من عدم اليقين ليست لها قوانين، الآثار فيها لا يمكن التنبؤ بها عن طريق النظر إلى مسبِباتها.
وهكذا كان المسرح جاهزًا لواحدة من أبرز الجدالات في تاريخ العلوم، الجدال بين بور وأينشتاين حول تفسير ميكانيكا الكم. كان نِزالًا بين فلسفتين؛ بين تَحيُزين لمجموعتين متضادتين من الأفكار الميتافيزيقية حول ماهية الواقع، وما يمكن أن نتوقعه من التمثيل العلمي للواقع. بدأ هذا الجدال في عام 1927 واستمر إلى أيامنا هذه، رغم أن أبطاله ليسوا معنا الآن.
ومازال الجدال غير محسوم.
ولو كان أينشتاين معنا هذه الأيام، لما اندهش أن الجدل حول ميكانيكا الكم لم يُحسم حتى الآن. ففي فبراير 1954، قبل وفاته بأربعة عشر شهرًا، قال أينشتاين في خطاب إلى الفيزيائي الأمريكي ديفيد بوم «إذا كان الإله هو خالق الكون، فمن المؤكد أن هدفه الأساسي كان أن يجعل فهمه عصيًا علينا».
هذا المقال مُترجم عن مجلة «إيون» Aeon، كتبه جيم باغوت، الكاتب البريطاني الحائز على جوائز والمتخصص في الكتابات العلمية. وقد حرَّر المقال الأصلي نايجل ووربورتن.
- Popular Books on Natural Science (1880) ↩︎
- Critique of Pure Reason (1781) ↩︎
- نظرًا لتشابه فلسفتهما. ↩︎
- قد يُفسر وصف الكاتب للدالات الموجية بالغموض على أساس أن نتائجها محتملة الحدوث وليست حتمية الحدوث. ↩︎
متخصص في كتابة ومراجعة المحتوى التعليمي العلمي، حاصل على ماجستير في علوم الحياة الطبية، وشغوف بعلم الأحياء الجزيئي وبمعرفة كل التروس الصغيرة التي تحرك العالم.
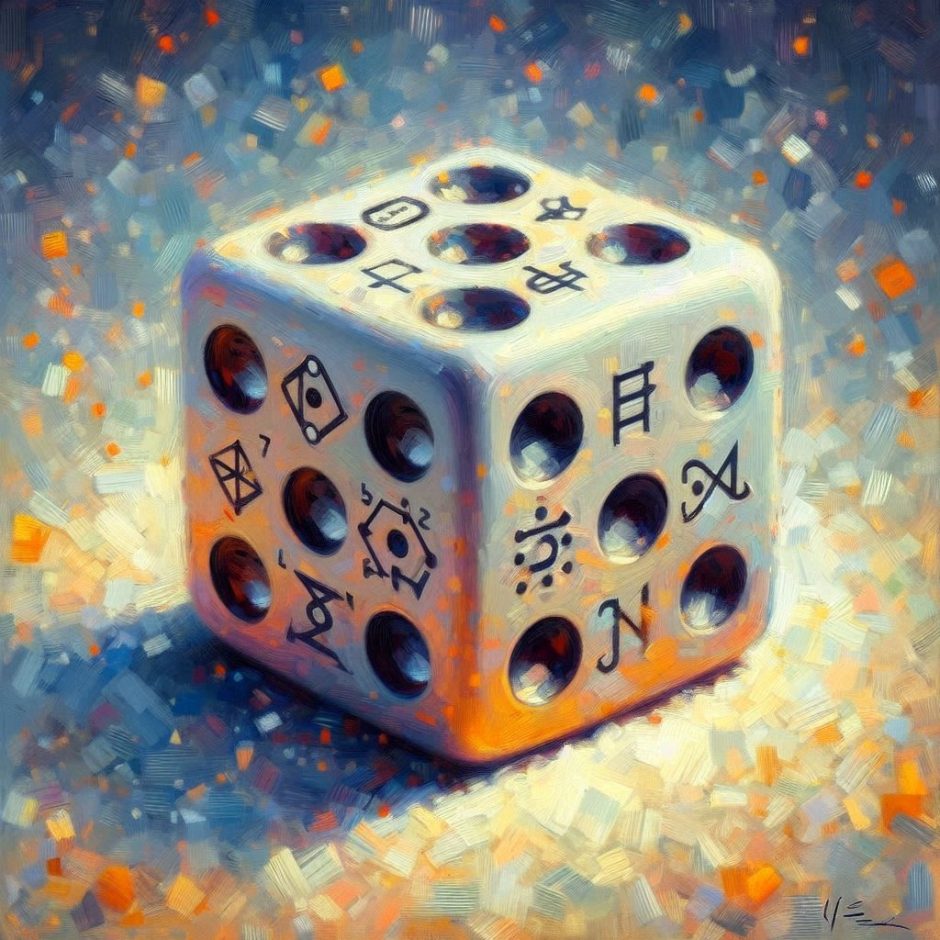
كنت أتمنى لو طال المقال.. فالموضوع مثير جدًا! تلك المنطقة بين الفلسفة والعلم التجريبي تدفع بأسئلة وحيرة أكثر مما تمنح من إجابات.
ترجمة جميلة يا أحمد 😃